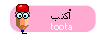[center]إنّ النّاظر بعين سليمة لأحوال البشر في هذا العالم المتصارع ليشفق عليهم وهو يراهم يتخبّطون في ظلمات بعضها فوق بعض، فالتيّارات الفكريّة الفاسدة تعمُّ العالم، ونظم ضالة مضلة تسير البشر والشباب خاصة وفق مصالحها ومآربها الخاصة،مما جعل الخمور والفجور تشيع في المجتمعات، وتعاطي الحشيش والمخدرات، والجرائم تزداد في كل عام، فأصبح الفرد غير آمن على نفسه وعياله وماله وعرضه، بل أصبح العرض مشاعا، والزنا مباحا، فسقطت دول وإمبراطوريات عظيمة بسبب تفسخ شبابها، وانحطاط مجتمعها، فلا دين ولا خلق، ولا سمو ولا كرامة، فقام مصلحون كثر يطالبون بإصلاح المجتمع عن طريق إصلاح وسائل الإعلام، وغيرهم يطالب بالإصلاح عن طريق صلاح مناهج التربية والتعليم، وثالث يطالب بالإصلاح عن طريق منع الخمور كما حصل في أمريكا، واستمرت المناداة واستمرت البحوث، ودخلت نتائج بعض البحوث مضمار الممارسة العملية لإصلاح المجتمع، فانتكست أكثر من ذي قبل، وشاع الفساد، وعم الخراب وزاد الإجرام لعدم طرق الباب الاصيل الذي به يكون العلاج.
وقام مصلح أسترالي وقال في كتاب نشره ما معناه:"إن العالم يتخبط في تيارات فاسدة وقد سُئلتْ كل الأمم عن حلول ناجعة ناجحة لعلاج تلك المفاسد فلم تجد، وبقيت هناك أمة لم تسأل، وأظن أن لديها العلاج الشافي، ألا إنها أمة الإسلام".
فالإسلام ينشئ علاقة بين الفرد وخالقه، فهو يرجو الثواب، ويهاب العقاب، فيصلح خلقه في كل زمان ومكان، بعكس الحال لدى غير المسلمين حيث يرجون الثواب من رؤسائهم، فإذا غفلوا عنه أساؤوا. وغلى ذلك تنبه أحد ضباط المرور الإنجليز فقال:"أنتم أيها المسلمون لو كان عندنا في كتابنا آية كالتي في قرآنكم ما احتجنا لنظام وقانون مرور ينظم السير، مشيرا إلى قوله تعالى:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" (سورة ق: آية 18).
فالمسلم يتقي الله حيثما كان، صدوقٌ في كلّ المواضع حتّى ولو على نفسه. وأتصور بعضا من النّتائج للتّعامل بالأخلاق الإسلاميّة في نوعين:
أولا: نتائج للفرد:
* شعوره بالطمأنينة والراحة النفسية في طل مجالات حياته.
* أمنه على نفسه وماله وعرضه وممتلكاته العامة.
* حصوله على حقوقه كاملة؛ وإعطاؤه لمجتمعه ما يجب عليه كاملا.
* زيادة إنتاج وعطاء الفرد لمجتمعه.
* شيوع روح المحبة والألفة والترابط بين أفراد المجتمع.
ثانيا: بالنسبة للأمة:
* قوة الأمة و الزيادة في إنتاجها.
* حلول البركة من الله تعالى والرضا عليهم.
* احترام سائر الأمم لهذه الأمة؛ وجعلها قدوة لهم.
* هيبة سائر الأمم لهذه الأمة.
* رقي هذه الأمة يكون أسرع من باقي الأمم.
وقد يسأل سائل أو يعترض معترض فيقول: ما الدليل على حصول هذه النتائج حالما تطبق الشريعة الإسلامية بنظمها وأخلاقها؟
فتقول: إن الأمر مرهون بالتجارب، وهناك تجربة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، حيث كانت أمة العرب لا يؤبه لها ولا يعتد بها، ولا يحسب لها أدنى حساب بين باقي الأمم، مثل فارس والروم والإغريق وغيرهم...،فقد كان العرب ينضح مجتمعهم بالجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء من وأد للحاجة البشرية لأخلاق الإسلام
إنّ النّاظر بعين سليمة لأحوال البشر في هذا العالم المتصارع ليشفق عليهم وهو يراهم يتخبّطون في ظلمات بعضها فوق بعض، فالتيّارات الفكريّة الفاسدة تعمُّ العالم، ونظم ضالة مضلة تسير البشر والشباب خاصة وفق مصالحها ومآربها الخاصة،مما جعل الخمور والفجور تشيع في المجتمعات، وتعاطي الحشيش والمخدرات، والجرائم تزداد في كل عام، فأصبح الفرد غير آمن على نفسه وعياله وماله وعرضه، بل أصبح العرض مشاعا، والزنا مباحا، فسقطت دول وإمبراطوريات عظيمة بسبب تفسخ شبابها، وانحطاط مجتمعها، فلا دين ولا خلق، ولا سمو ولا كرامة، فقام مصلحون كثر يطالبون بإصلاح المجتمع عن طريق إصلاح وسائل الإعلام، وغيرهم يطالب بالإصلاح عن طريق صلاح مناهج التربية والتعليم، وثالث يطالب بالإصلاح عن طريق منع الخمور كما حصل في أمريكا، واستمرت المناداة واستمرت البحوث، ودخلت نتائج بعض البحوث مضمار الممارسة العملية لإصلاح المجتمع، فانتكست أكثر من ذي قبل، وشاع الفساد، وعم الخراب وزاد الإجرام لعدم طرق الباب الاصيل الذي به يكون العلاج.
وقام مصلح أسترالي وقال في كتاب نشره ما معناه:"إن العالم يتخبط في تيارات فاسدة وقد سُئلتْ كل الأمم عن حلول ناجعة ناجحة لعلاج تلك المفاسد فلم تجد، وبقيت هناك أمة لم تسأل، وأظن أن لديها العلاج الشافي، ألا إنها أمة الإسلام".
فالإسلام ينشئ علاقة بين الفرد وخالقه، فهو يرجو الثواب، ويهاب العقاب، فيصلح خلقه في كل زمان ومكان، بعكس الحال لدى غير المسلمين حيث يرجون الثواب من رؤسائهم، فإذا غفلوا عنه أساؤوا. وغلى ذلك تنبه أحد ضباط المرور الإنجليز فقال:"أنتم أيها المسلمون لو كان عندنا في كتابنا آية كالتي في قرآنكم ما احتجنا لنظام وقانون مرور ينظم السير، مشيرا إلى قوله تعالى:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" (سورة ق: آية 18).
فالمسلم يتقي الله حيثما كان، صدوقٌ في كلّ المواضع حتّى ولو على نفسه. وأتصور بعضا من النّتائج للتّعامل بالأخلاق الإسلاميّة في نوعين:
أولا: نتائج للفرد:
* شعوره بالطمأنينة والراحة النفسية في طل مجالات حياته.
* أمنه على نفسه وماله وعرضه وممتلكاته العامة.
* حصوله على حقوقه كاملة؛ وإعطاؤه لمجتمعه ما يجب عليه كاملا.
* زيادة إنتاج وعطاء الفرد لمجتمعه.
* شيوع روح المحبة والألفة والترابط بين أفراد المجتمع.
ثانيا: بالنسبة للأمة:
* قوة الأمة و الزيادة في إنتاجها.
* حلول البركة من الله تعالى والرضا عليهم.
* احترام سائر الأمم لهذه الأمة؛ وجعلها قدوة لهم.
* هيبة سائر الأمم لهذه الأمة.
* رقي هذه الأمة يكون أسرع من باقي الأمم.
وقد يسأل سائل أو يعترض معترض فيقول: ما الدليل على حصول هذه النتائج حالما تطبق الشريعة الإسلامية بنظمها وأخلاقها؟
فتقول: إن الأمر مرهون بالتجارب، وهناك تجربة سجلها التاريخ في أنصع صفحاته، حيث كانت أمة العرب لا يؤبه لها ولا يعتد بها، ولا يحسب لها أدنى حساب بين باقي الأمم، مثل فارس والروم والإغريق وغيرهم...،فقد كان العرب ينضح مجتمعهم بالجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء من وأد للبنات والثأر الظالم والخمور والفجور، والزنا والكرامات المهدرة للعبيد والمستضعفين، وضياع الحقوق ما لم تسندها قوة، فلما جاء هذا الدين أخرج من العرب بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، فدكت حصون الأمم الأخرى، وتفوقت عليها بالعلم والعلماء، حتى أصبحت المدن الإسلامية منابر علم تقصدها الأمم لتنهل منها، وفي هذا الوقت جيء بتاج كسرى ذلك التاج العظيم محمولا على حمار من المدائن إلى المدينة وألقي بين يدي رجل عليه صياب مرقعة،وأصبحت أمة الإسلام كالبُنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضا، وأضحى المسلم لأخيه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.بنات والثأر الظالم والخمور والفجور، والزنا والكرامات المهدرة للعبيد والمستضعفين، وضياع الحقوق ما لم تسندها قوة، فلما جاء هذا الدين أخرج من العرب بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، فدكت حصون الأمم الأخرى، وتفوقت عليها بالعلم والعلماء، حتى أصبحت المدن الإسلامية منابر علم تقصدها الأمم لتنهل منها، وفي هذا الوقت جيء بتاج كسرى ذلك التاج العظيم محمولا على حمار من المدائن إلى المدينة وألقي بين يدي رجل عليه صياب مرقعة،وأصبحت أمة الإسلام كالبُنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضا، وأضحى المسلم لأخيه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.